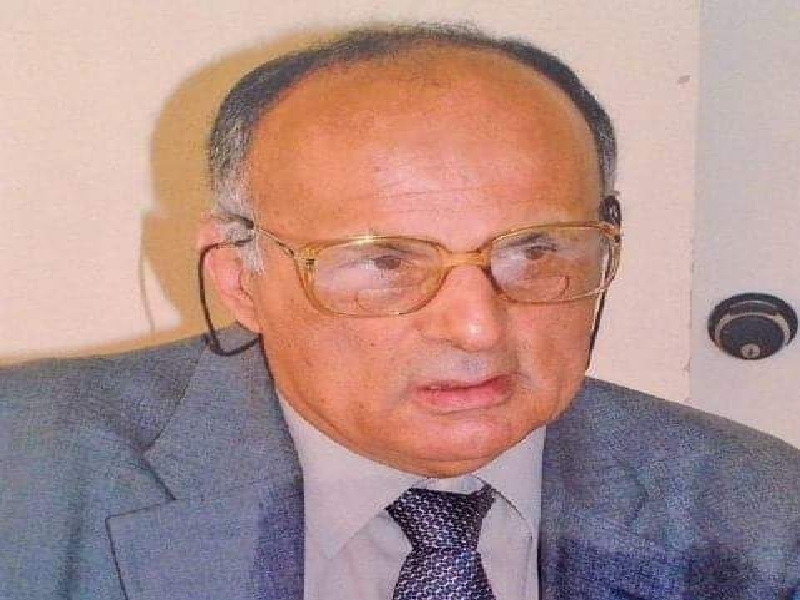مع عبد المجيد زراقط في النقد كل اثنين | نظريات النقد الأدبي البنيوي وما بعده (6)/ جريدة الأيام الإلكترونية
أ. د. عبد المجيد زراقط :
١٢ - جاك دريدا/ التفكيكيَّة = deconstruction "التفكيكيَّة" نظريَّة نقديَّة من نظريَّات "ما بعد البنيويَّة". بلغت الترجمات العربيَّة لمصطلح deconstruction ما يزيد على عشرة أسماء، منها: التفكيك، التفكيكيَّة، التقويض، التقويضيَّة، التَّشريح، التشريحيَّة، النَّقضية، النَّقض، اللاَّبناء، التَّهديم، التحليلية البنيويَّة، الانزلاقيَّة، النَّقضيَّة، نظريَّة التقويض...، وقد اعتمدنا مصطلح "التفكيكيَّة" لدلالته اللُّغويَّة، ولشيوعه وانتشاره. يعود ميلاد "التَّفكيكيَّة" الرَّسمي إلى سنة 1966، ففي شهر تشرين الأوَّل، من هذه السَّنة، نظَّمت جامعة "جون هوبكنز"، في الولايات المتحدة الأميركية، ندوة موضوعها "اللغات النَّقديَّة وعلوم الإنسان"، شارك فيها أعلام النَّقد العالمي المعاصر (رولان بارت، تزفستيان تودوروف، لوسيان غولدمان، جورج بولي، جاك لاكان، جان دريدا...). قدَّم دريدا (15/7/1930 – 9/10/2004)، في هذه النَّدوة، بحثاً عنوانه "البنية والعلامة واللَّعب في خطاب العلوم الإنسانيَّة" عُدَّ "البيان التَّفكيكي الأوَّل". وفي سنة 1967، أصدر ثلاثة كتب مثلَّت مصادر "التفكيكيَّة" الأساس، وهي: "الكتابة والاختلاف"، "الصَّوت والظَّاهرة"، "في علم الكتابة". ثم أصدر، في سنة 1972، كتباً أخرى، منها: "التشتيت"، "مواقف"... أسهمت في بلورة نظرية "التفكيك" وتعميقها وشرحها.
يتحدَّث "تيري إيغلتون" عن السِّياق المجتمعي الذي ولدت فيه نظريات "ما بعد البنيويَّة"، ومنها "التَّفكيكيَّة"، فيقول: النَّص، كما يعلن "بارت" "هو ذلك الشخص المنفلت الذي يكشف قفاه للأب السَّياسي". وهذه الإشارة إلى "الأب السيَّاسي"، كما يرى "تيري أيغلتون"، ليست مصادفة، فقد نُشر كتاب "بارت" "لذَّة النَّص" بعد خمس سنوات من انفجار اجتماعي هزَّ آباء فرنسا السِّياسيِّين حتَّى جذورهم. ففي سنة 1968 اندفعت الحركة الطَّالبيَّة بقوَّة عبر أوروبَّا... وإن لم تكن قادرة على كسر بنى سلطة الدَّولة، فقد وجدت أنَّه من الممكن تدمير اللغة عوضاً عن ذلك. "وهكذا أصبح كلّ فكر نظامي كلِّي موضع شبهة، بوصفه فكراً إرهابياً"().
قد يكون في هويَّة "دريدا" ما يشير إلى هوية هذه الحركة التي أسَّسها، فهو يقول: "أنا يهودي جزائري، يهودي لا، يهودي بالطَّبع. لكنَّ هذا كافٍ لتفسير العسر الذي أتحسَّسه داخل الثَّقافة الفرنسيَّة. لست منسجماً، إذا أجاز التَّعبير. أنا أفريقي شمالي بقدر ما أنا فرنسي"().
تعرَّف "جوزيت راي دوبوف"، في قاموسها السِّيميائي، فعل التَّفكيك، عند "دريدا"، بمعنى "فكِّ" = deffaire بناء ايديولوجي موروث، أو تقويضه، اعتماداً على التحليل السيميولوجي. ويقول "دريدا": عندما وضعت هذا المصطلح كنت أفكِّر في استخدام "هيدغر" لكلمة "التدمير"، بمعنى تحليل بنية ما، من طريق نشرها وبسطها على طاولة التشريح، كما كنت أفكِّر في كلمة ألمانية استعملها "فرويد" تدل على نوعٍ من التركيب بالمقلوب، لكنَّني آثرت هذه الكلمة لدلالتها على ما أريد().
يعدُّ "دريدا" ناقداً كبيراً يجيد الجدل الفلسفي والأدبي، ففي قراءته لنصوص الفلسفة الغربيَّة، رأى أنَّ محورها هو ما سمَّاه "مركزية الكلمة، أو ميتزيقيا الحضور، وأنَّ نظريَّات هذه الفلسفة هي صيغ نظام واحد، وإن كان من غير الممكن التَّخلُّص من هذا النِّظام، فإنَّه يمكن نقده من الدَّاخل، من طريق الميتافيزيقيا، وقلبها رأساً على عقب. وفي قراءته للنُّصوص الأدبية بيَّن أنَّ أيَّ نصٍّ، من هذه النُّصوص، هو نسيج غير متكامل يتشكَّل من خيوط مختلفة.
نشر "دريدا" أوَّل أعماله: "أصل الهندسة" – 1962، وهو مقدَّمة طويلة لبحثٍ كتبه الفيلسوف الظَّاهراتي الألماني "أدمند هوسيرل" (1859 - 1938) عن أصل الهندسة. ثم أخذ ينشر المقالات في المجلَّات الفكريَّة الفرنسيَّة. وفي سنة 1967، أصدر ثلاثة كتب هي: "في الكتابة" و"الكتابة والاختلاف" و"الكلام والظَّواهر". في "في الكتابة" بحث في القضايا التي يتضمَّنها الترتيب الذي يقدِّم الكلام على الكتابة، وبيَّن أنَّ الخصائص التي يوصف بها الكلام تنطبق على الكتابة، وبحث في إمكان عكس الترتيب، وفي توجيه "نظرية اللغة" نحو الكتابة. ويتضمَّن "الكتابة والاختلاف" مجموعة مقالات تبحث في أعمال عدد من كبار الأدباء والمفكِّرين المعاصرين والنَّظريات التي يمثلِّونها. ومن هذه المقالات المقالة التي شارك بها في مؤتمر "جامعة جونز هوبكنز - 1966"، وفيها يرى، بعد أن يقارن بين تصوُّرين للتفسير: 1- معنى أصلي، 2- عدم إمكان تثبت المعنى، أن ليس من إمكانيَّة لتثبيت معنى أصلي، أو حقيقة أصليَّة في التفسير. ويُخصَّص "الكلام والظَّواهر" للتحليل الفلسفي، فيبحث في نظرية "هوسيرل" عن العلامات، وخصوصاً فكرتي الصَّوت والحضور.
وفي سنة 1972، نشر ثلاثة كتب هي: "حواشي الفلسفة" و"الانتشار" و"مواقف"، يتضمَّن "حواشي الفلسفة" مجموعة مقالات في التحليل الفلسفي، منها مقالة "la differance" المشهورة. ويتضمن "الانتشار" ثلاث مقالات تبحث في قضايا أدبيَّة، ويتضمن "مواقف" ثلاث مقابلات. وفي سنة 1974، نشر كتاب "Glas" وهو كتاب يتميَّز بطريقة تشكيل الكتابة فيه؛ إذ قسَّمه إلى قسمين عموديين، يتضمَّن أوَّلهما تحليلاً لمفهوم العائلة عند "هيغل"، ويتضمَّن ثانيهما نقاشاً لاقتباسات من "جان جينيه" وتعليقات عليها. هذا إضافة إلى مقالات كثيرة لم يجمعها في كتاب. "إنَّ قراءات دريدا للنُّصوص المختلفة والنُّصوص التي وضعها هو تشكِّل كلُّها استكشافات لمركزية الكلمة الغربيَّة. وميتافيزيقيا الحضور التي يمكن القول: إن هذه النُّصوص تؤكِّدها وتزعزعها، في آن، هي الميتافيزيقيا الوحيدة التي نعرفها، وهي تكمن خلف تفكيرنا كلِّه. ولكن يمكن القول أيضاً: إنَّ هذه الميتافيزيقيا تؤدِّي إلى مفارقات تتحدَّى تناسقها وتماسكها الفكري. ولذا، فإنَّها تتحدَّى إمكان تحديد الوجود، بوصفه حضوراً...". والمثال الآتي يوضح ما تتضمَّنه فكرة ميتافيزيقيا الحضور: "... إنَّ اللحظة الرَّاهنة هي ما هو موجود. المستقبل سوف يوجد والماضي وُجد. ولكن حقيقة كلٍّ منهما تعتمد على حضور الحاضر: المستقبل حضور متوقَّع، والماضي حضور سابق...". والمبدأ نفسه يصحُّ على دوالّ اللغة، "فسلسلة الأصوات "بات"، مثلاً، لا يمكنها أداء وظيفتها رمزاً، باعتبارها رمزاً، إلاَّ لأنها تختلف عن "ذات وفات ومات وقات وباد وبوت، إلخ". فالصوت الذي نحدثه، عندما نلفظ كلمة "بات"، يضم في ثناياه آثاراً من الرموز الأخرى التي لم نلفظها. وكما رأينا، في حالة الحركة، فإن ما هو حاضر هو ذاته معقَّد يعتمد على سلسلة من الاختلافات"(). والسُّؤال الذي يطرح هنا، هو: ما هي الميتافيزيقيا؟ الميتافيزيقيا = الماورائيَّة تعني فلسفة ما وراء الطبيعة التي تنكر التناقضات الداخلية بين الأشياء(). والعقل، في الميتافيزيقيا الغربيَّة، هو الذي يدرك ما يحضر لديه ويعيه. وهذا الذي يحضر هو الوجود وما يغيب هو العدم، ما يعني أنَّ الميتافيزيقيا الغربيَّة هي ميتافيزيقيا الحضور. عمل "دريدا" على تفكيك هذه الميتافيزيقيا من داخلها، ورأى أن ليس من حضور واحد ثابت، وإنَّما يوجد اختلاف وغياب.
المسلَّمات الميتافيزيقية الأساسيِّة للفلسفة الأوروبيَّة تقرِّر وجود مركز من نوعٍ ما للمعنى حتَّى في البنيويَّة. هذا المركز يحكم البنية، لكنَّه ليس موضوعاً للتحليل البنيوي، وذلك لأن إيجاد بنية للمركز يعني إيجاد مركز آخر. وضع "دريدا"، في بحثه: "البنية والعلامة واللَّعب في خطاب العلوم الإنسانيَّة"، البنية موضع الشَّك، وذهب إلى أنَّ البشر يرغبون في مركز، لأنَّ المركز يضمن لهم الوجود، من حيث هو حضور، ويعتقدون بأنَّ المركز هو "الأنا"، غير أنَّ نظريَّة "فرويد" قوَّضت هذا الاعتقاد، بالكشف عن انقسام الذَّات بين الشُّعور واللَّاشعور.
يرى "دريدا" أنَّ تفكيك مفهوم مبدأ من المبادئ المركزية يوقع في خطر استحداث مركز جديد، وكلُّ ما يمكن القيام به هو "رفض السَّماح لأيٍّ من القطبين في نسق ما (جسد/روح، خير/شرّ، جاد/هازل) بأن يكون هو المركز وضمان الحضور"().
ويقرِّر أنَّ الفكر الميتافيزيقي الماورائي الغربي صرح أو معمار يجب تقويضه، من دون إعادة بنائه. "والقراءة التقويضيَّة هي قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النَّص (مهما كان) دراسة تقليديَّة، أوَّلاً، لإثبات معانيه الصَّريحة، ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النَّص من معانٍ تتناقض مع ما يصرِّح به"، وتبيِّن الاختلاف بين ما يصرِّح به النَّص وما يخفيه. تقلب هذه القراءة كل ما كان سائداً في الفلسفة الماورائية، سواء أكان ذلك المعنى الثَّابت أو الحقيقة القارَّة، أو العلميَّة، أو المعرفة، أو الهوية، أو الوعي، أو الذات المتوحِّدة، باختصار كل الأسس التي يقوم عليها الخطاب الفلسفي الغربي().
ويثار، هنا، السؤال: ما هو المركز؟ وما هي النزعة المركزية؟
يطلق "دريدا" على الرَّغبة في المركز مصطلح "نزعة مركزيَّة "اللُّوغوس" (الكلمة التي تعبِّر عن الفكر الدَّاخلي، وعن العقل، بوصفه مبدأ الوجود)، ويرى أنَّ تفضيل الكلام على الكتابة، أو ما يسمَّى "نزعة مركزيَّة الصَّوت" هو صفة أصليَّة مميِّزة لمركزيَّة "اللُّوغوس" = الكلمة. لكن هذه الكلمة = العلامة ليس لها حضور كامل. لماذا؟ يجيب "دريدا" عن هذا السُّؤال، فيضع كلمة، في اللغة الفرنسيَّة، يكشف بها انقسام العلامة، وهي "differance" التي لا يسمعنا نطقها صوت الحرف "a"، فندرك، من حيث الصَّوت، أنَّها "difference" التي تشير إلى الاختلاف. هذا الالتباس لا يمكن إدراكه إلاَّ في الكتابة، فالفعل "differer" يشير إلى الاختلاف والإرجاء على السَّواء، ما يعني أنَّ الفكر الذي يقوم على مركزيَّة الصَّوت يتجاهل عنصر الإرجاء "differance"، ويلحُّ على حضور الكلمة المنطوقة نفسها(). وهذا يفيد أمرين: أوَّلهما أن ليس للعلامة حضور كامل/مركز ثابت، وثانيهما، أنَّ ليس من تراتب يعلي الكلمة المنطوقة على الكلمة المكتوبة. وإذ يفعل ذلك يفكِّك/يقوِّض المركز والتَّراتب القديم النَّاتج عن "نزعة مركزيَّة الصَّوب" التي ترى أنَّ الكتابة شكلٌ غير صافٍ من الكلام، وأن الكلام أقرب إلى الفكر الخاص، لكنَّه لا يستبدل تراتبياً بآخر، وإنما "يحاول أن يؤسِّس لكتابة تقوم على الاختلاف، ومنهج يقوم على كشف الاختلاف الدَّائم في الكتابة". وإن يكن "دريدا" يجري قراءات تفكيكيَّة، فما الذي يهمُّه من هذه القراءات؟ يقول دريدا: "ما يهمُّني، في هذه القراءات التي أحاول إنجازها، ليس النَّقد من الخارج، بل الاستقرار، أو التموضع، داخل البنية غير المتجانسة، للعثور على مؤثِّرات، أو تناقضات داخليَّة يقرأ النَّص ويفكِّك، خلالها، نفسه"(). ففي النَّص، كما يضيف، توتُّرات وفجوات تجعله قابلاً لقراءات مفسِّرة ومؤوِّلة لا نهاية لها، وهذا هو "الاختلاف" الذي يتمثَّل في الكتابة، ويكون على القارئ أن يتبيَّنه في قراءته، ومن هنا كان العدول عن دراسة النَّص إلى قراءة الخطاب التي تعدّ، في النَّظرية "ما بعد البنيويَّة" خطاباً على الخطاب تقول ما يقوله القارئ، وليس ما يقوله الكاتب. وهنا تتبدَّى ثنائية الحضور – المَرْكزة ≠ الغياب – الاختلاف، فالانتشار. وإن تكن "التفكيكية" قراءة نصوص، فإن "دريدا" يقول: "ليس من نصٍّ متجانس. في كلِّ نصٍّ عناصر تفكيك له تتيح استنطاقه وجعله يتفكَّك. لهذا فقراءته تتمُّ من داخله، بغية العثور على "توتُّرات أو تناقضات داخلية" تجعل النَّص يفكِّك نفسه بنفسه، و"لا يوجد نصٌّ مغلق ولا قراءة نهائيَّة، بل توجد نصوص بعدد قرَّاء النَّص الواحد، ومن ثم تصبح كل قراءة نصَّاً جديداً أو مبدعاً"(). وهذا يعني أنَّ القراءة مستمرَّة، وأنَّ النَّص يُنتج باستمرار، ولا يتوقَّف بموت كاتبه. لهذا فدريدا يدعو إلى الكتابة بدلاً من الكلام، بوصفها كائناً باقياً في غياب كاتبها، في حين يتعذَّر ذلك بالنِّسبة إلى الكلام.
في ما يتعلَّق بالإجراءات النَّقديَّة، يقول "دريدا": "ليس التفكيك منهجاً، ولا يمكن تحويله إلى منهج، خصوصاً إذا ما أكَّدنا على الدَّلالة الإجرائيَّة أو التّقنيَّة"().
طريقة القراءة التفكيكية = lecture deconstructiviste تتمثَّل، بدايةً، في "فتح" النَّص على قراءات وعدم إغلاقه على قراءة واحدة، والقراءات تتبيَّن للدَّالِّ مدلولات لا مدلولاً واحداً، وكلُّ مدلول يصبح دالاً ذا مدلولات، وهكذا...، فينتشر المعنى... "التفكيك"، إذاً، هو قراءة النَّص باستخدام مجموعة مصطلحات/مبادئ أهمها: الاختلاف defference، وهو، كما يعرِّفه "دريدا": "فاعلية حرَّة غير مقيَّدة لا يعود إلى التاريخ ولا إلى البنية، وإنما يوجد ببساطة في اللُّغة، ليكون أوَّل الشروط لظهور المعنى(). والاختلاف يفضي إلى التَّشتُّت والانتشار والتَّفرُّق في المكان والزمان، وإلى تعارض الدَّلالات بين الحضور والغياب، ما يجعل النَّصَّ تياراً لا متناهياً من الدَّلالات وتوالد المعاني لا تعرف الاستقرار والثَّبات. وأيُّ قراءة تتبيَّن دلالاتٍ هي قراءة غير نهائية، إذ تبقى دلالات مؤجَّلة ضمن نظام الاختلاف، محكومة بحركتين: أفقيَّة وعمودية، من دون توقُّع لنهاية محدَّدة لها.
وهذا يعني إعطاء السُّلطة الحقيقية للقارئ لا للمؤلِّف، ما يفضي إلى إعلاء شأن الكتابة على الكلام، ذلك أنَّ الكتابة تكتسب أهميتها من تمركزها في العقل؛ حيث يصبح الكلام مستحيلاً. لهذا يضع الكاتب أفكاره على الورق، فاصلاً إياها عن نفسه ومحوِّلاً إياها إلى شيء قابل لأن يُقرأ من شخصٍ آخر بعيد حتَّى بعد موت الكاتب. وكل هذا يفتح الآفاق لمزيد من الاحتمالات. ومن هنا ينشأ الاختلاف الكبير بين الكلام والكتابة(). ونعيد السؤال هنا: هل "التفكيكية" منهج؟ فنقرأ إجابة "دريدا": ليس التفكيك "تحليلاً analyse، ولا نقداً critique"، وليس "منهجاً، ولا يمكن تحويله إلى منهج، وخصوصاً إذا ما أكَّدنا على الدَّلالة الإجرائية أو التِّقنيَّة" ويضيف: "ما الذي يكوِّن التفكيك؟ كل شيء، ما التفكيك؟ لا شيء"().
يفيد هذا القول - النفي، والنَّفي الحاضر يستدعي الإيجاب الغائب، وفاقاً لطريقة التفكيك في القراءة، أنَّ التفكيك قراءة، وليس أيَّ قراءة، وإنَّما طريقة في القراءة. وإن كان الخطاب، كما يقول "فوكو"، هو "مقروء النَّص"، فإن قراءة "التفكيك" هي خطابٌ من خطابات النَّص الأدبي
* الدكتور عبد المجيد زراقط. أكاديمي. ناقد أدبي. قاص وروائي.
جريدة الأيام الإلكترونية. الصفحة الثقافية
- علامات:
- إقتصاد